رواية “أصوات عالية في الطريق إلى الشمال” لهيام الفرشيشي/ قراءة تأويلية
الباحثة سوسن الطيب العجمي/ تونس
في مفهوم العتبات النصية ودورها في تشكيل المعنى
تُعد العتبات النصية وفق المفهوم الذي بلوره جيرار جينيت عناصر مرافقة للنص تُسهم في تشكيل أفق التلقي، وتمنح القارئ مفاتيح أولية لفهم العالم التخييلي. ويأتي الغلاف، والعنوان، والمداخل البصرية ضمن هذه العتبات التي، رغم كونها خارجية شكليا، فإنّها تُرسّخ دلالات محورية تُضيء مغاليق النص وتُمهد للولوج في مساراته الرمزية. وفي رواية “أصوات عالية في الطريق إلى الشمال” للكاتبة هيام الفرشيشي، تتجلى هذه العتبات في صورة الغلاف، وتوزيع العناصر البصرية، والعنوان، بوصفها علامات دالة تتشابك لتبني شبكة رمزية تمهّد لحفر أعمق في البنية السردية.
صورة الغلاف
جسد الأنثى نافذة رمزية على الذات والكينونة
تُقدّم لوحة الغلاف فتاة من الخلف، تختفي ملامحها كأنها تنسحب من الضوء نحو العتمة، أو تتأمل في صمت أزلي. هذه الوضعية ليست بريئة، بل تثير تساؤلات عن الهوية، والذات، والصمت الأنثوي. هل هي خيرة، الشخصية المتأملة في مصيرها؟ أم سارة، التي تبحث عن هوية جديدة تتخطى الألم؟ أم أنها الراوية ذاتها، التي تسعى إلى التماهي مع العالم من خلال التأمل العكسي بدل المواجهة؟
إنّ هذا الغياب للملامح يفتح أفقا تأويليا خصبا، يشحن اللوحة بدلالات تتراوح بين العزلة والانبعاث.
مركز اللوحة والنهر: تدفق الزمن وتحوّل الذات
يحتل النهر موقعا مركزيا، ليمثل حركة مستمرة في مقابل ثبات الجسد الأنثوي. هذا التوازي بين السكون والتدفق يحيل إلى الصراع الداخلي الذي تعانيه الشخصية، بين ماض يريد أن يُنسيها إياه النهر، ومستقبل تحاول أن تُشكله بعيدا عن شوائب الانكسار. يتخذ النهر في العديد من المتون السردية معنى التطهر أو الفناء أو التجدّد، وهو في هذه اللوحة رمز للتدفق الداخلي النفسي. أما جسد الفتاة المرسوم بتشكيل هندسي يشبه الخطوط فيحمل توترا، يشي بإرادة مقاومة ضمنية، أو ربما انكسار مقنّع.
الألوان وتوزيعها الرمزي : جدلية الضوء والعتمة
يأتي اللون كفاعل رمزي في هذه اللوحة. الأصفر الدافئ يتموضع في اليمين، بينما يسيطر الأزرق الداكن على الجهة اليسرى. بين هذين القطبين يتولد الأخضر، الذي يحيل إلى الحياة والنماء. توزيع الألوان بهذا الشكل لا ينفصل عن التحوّلات النفسية للشخصية. فالأصفر يُمثّل بارقة الأمل، والأزرق الداكن يُجسّد العوالم الداخلية المعتمة، في حين أن الأخضر هو المساحة الانتقالية التي تَعد بالتجدّد الروحي. الرؤية من الخلف انعدام التواصل البصري.
من الخفاء إلى الانكشاف التدريجي
غياب وجه الفتاة ليس مجرّد تفصيل بصري، بل هو تمثيل لماضٍ مشروخ، لهوية لم تكتمل، ولصوت لم يُسمع بعد. إنّ اختيار وضعية الظهر ينطوي على بعد سيكولوجي عميق، يعكس مأساوية التجربة الأنثوية في مجتمعات تفرض الصمت وتُؤطّر الجسد بمفهوم الآلة. فالراوية تُخفي ملامحها ليس لأنها مجهولة، بل لأنها تخوض رحلة شفاء تبدأ من التجاهل وتنتهي بالرغبة في الانكشاف. هذا “الانحراف البصري” عن الواجهة يُمثّل عملية تفكيك للذات قبل إعادة بنائها.
العنوان ودور الطريق كاستعارة للوجوه
“أصوات عالية في الطريق إلى الشمال”: عنوان يشتبك مع مخيال الرحلة، ويفتح أفقا للانتقال الجغرافي والنفسي. “الطريق” ليس معبرا مكانيا، بل سردية داخلية تعكس البحث عن الذات، وعن معنى في عالم مشتّت. الشمال ليس مجرد جهة، بل أمل، نور، خلاص. أما “الأصوات العالية”، فهي صرخات الداخل، احتجاجات الراوية على القهر، على النسيان، على الانطفاء. العنوان إذن يُجسّد صراعا بين الداخل والخارج، بين الصمت المفروض والصوت المستعاد.
المرأة والطريق: أجساد تمشي على شفير المعنى
تتجلى المرأة في الرواية بوصفها كائنا في حالة عبور دائم. الطريق الجبلي، الملتوي، لا يُجسّد التضاريس الطبيعية فقط، بل يُعيد تشكيل العلاقات بين الذات والآخر، بين التاريخ الشخصي والمجتمع. المرأة، في هذه الرواية، ليست رمزا للضعف، بل موضوع مقاومة. حضورها الجسدي في الطريق هو فعل هووي ثقافي، يتحدى المفاهيم النمطية حول العزلة والضحية. الطريق يصبح أداة اختبار للصلابة، وإعلانا عن الذات رغم الانكسارات.
العتبات بنية دالة وأفق للتأويل
ليست العتبات في رواية “أصوات عالية في الطريق إلى الشمال” زينة خارجية أو مقدمة شكلية، بل هي مداخل رمزية لبنية سردية تتقاطع فيها الذات الأنثوية مع الفضاء، والزمن مع الجسد، والتاريخ الشخصي مع الواقع الاجتماعي. تُحوّل الكاتبة هيام الفرشيشي هذه العتبات إلى شيفرات محمّلة بالمعاني، تُثير القارئ وتدعوه إلى الانخراط في تجربة تأملية، لا تُفرغ من الداخل إلا لتعاد صياغتها من جديد، نحو ضوء خافت، هو شكل من أشكال النجاة.
الأنثى بين فجوة الذاكرة ومفترق الطرق: تمزق الهوية ومسارات الانتماء في رواية أصوات عالية في الطريق إلى الشمال.
تغوص رواية أصوات عالية في الطريق إلى الشمال لهيام الفرشيشي في تعقيدات الذات الأنثوية وهي تعبر مسارات شائكة من التكوين والتمزق. تشكل الرواية لوحة فسيفسائية من المشاهد والمواقف التي تكشف هشاشة الهوية الأنثوية، وتطرحها مثل كائن في طور التخلق المستمر، بين مكانين وزمانين، بين ذاكرة مثقوبة وأمل غامض.
منذ الصفحات الأولى، يتبدّى الطريق بفعل مجاز رمزي للعبور النفسي، حين تقول الساردة: “بعض الطرق تدعونا إلى قطعها وإن كنا نتوجس من عبورها، ليس لأنها طرق محفّرة أو مزدحمة، أو خطرة، بل لأنها تشبه الدور المهجورة…”. فالسرد هنا يُدخل القارئ في دروب الذات، حيث تصبح الطريق صورة للتصدّع الداخلي، وللانقسام الذي تعيشه المرأة بين وجهين أو شخصيتين: “أشق الطريق الغامض الذي يؤدي إلى شخصيتين متناقضتين…”. هذا التشظي الداخلي ينسجم مع تصور جوليا كريستيفا التي ترى أن “المرأة المعاصرة تسير نحو ذاتها من خلال اغترابها عنها”، حيث تتصارع داخلها الصور والأدوار.
يتمظهر هذا الصراع من خلال التباين بين “خيرة” و”سارة”. “خيرة” تمثل الجذر، الأرض، الذاكرة. فهي المرأة القروية التي “تقاوم حركة المياه المندفعة نحو التراب، تتدفق في وجهها هالات حمراء…”، صورة جسدية عنيفة تدل على الصلابة والتحمل، ولكنها أيضا امرأة مخنوقة بتاريخ من الحرمان، يتجلى في قولها وهي تشير إلى ثقب في الجدار: “ما رأيك لو نحضر كرسيين، لنطل من تلك الفجوة الكبيرة الشاهدة على ما عشته من ضياع وتيه؟”، فيحضر الجدار بوصفه جسدا مثقوبا، يحمل آثار الزمن والانكسار، تمامًا كما تصفه هيلين سيكسوس حين تقول إن “الأنثى تكتب جرحها من خلال الجدار المتهالك الذي يحيط بها”.
ويكتسب الفضاء قيمة سردية عميقة في مشهد “شجرة العائلة”، التي تقول عنها الساردة: “زرعها جدي وسماها شجرة العائلة… كانت الجدة تعجن الطين وتصنع الأواني الفخارية، وتعد العولة…”. هنا تتحول الشجرة إلى رمز للانتماء والذاكرة الحية، وهي عتبة رمزية للدفء العائلي، تذكّر بما يقوله غاستون باشلار عن “المكان الحميمي الذي يسكن الذاكرة ولا يغادرها، حتى إن فارقناه”.
غير أن الحنين لا يمنع الانكسار، حيث تتكثف الرمزية في لحظة استدعاء الطبيعة بوصفها امتدادًا للذات: “وكلما تدفّق الماء تتنفس الروح… وتنبعث روائح تحييني وتشابك مع أذهان أخرى ترى الشجرة بوضوح…”. فالشجرة هنا تُستدعى من الذاكرة لتكون نبضا حيا يعيد إحياء الذات، والشذى هو صوت العودة من الغربة الداخلية، والكتابة ذاتها تنهض مجددا: “ينهض القلم المتثائب من جديد باحثا عن تفاصيل جديدة لرحلة البحث عن الذات”، في محاكاة واضحة لفكرة الكتابة كفعل بعث.
النهاية المفتوحة:
تأتي القفلة السردية في صوت “سارة” عبر الهاتف: “لقد تمكنت من الإفلات من الأسر، وغيرت وجهتي إلى مدينة الضباب…”. هذه النهاية المفتوحة لا تعلن قرارا بل اختيارا: اختيار المجهول على الثبات، الغياب على الحضور. تقول سارة: “قد يكون أخي على حق، لا يجب أن أتواجد وخيرة في نفس المكان، الزيت والماء لا يلتقيان…”. هكذا تتبلور المفارقة بين شخصيتي “خيرة” و”سارة”: الأولى تمثل البقاء والجذر، والثانية تمثل الرحيل والانفلات.
وبين هذين القطبين، تقف الساردة، كعين راصدة، وذاكرة حائرة، شاهدة على الخروج والعودة، والتمزق بين ما كان وما سيكون. في هذا المعنى، تصير الرواية بأكملها تدوينا بليغا لرحلة الذات نحو هشاشتها الخاصة، حيث تقول هيلين سيكسوس: “على المرأة أن تكتب جسدها، وذاكرتها، وخيباتها، فهي وحدها قادرة على منح الحبر معنى النجاة”.
فهي المرأة القروية التي “تقاوم حركة المياه المندفعة نحو التراب، تتدفق في وجهها هالات حمراء…”، صورة جسدية عنيفة تدل على الصلابة والتحمل، ولكنها أيضا امرأة مخنوقة بتاريخ من الحرمان، يتجلى في قولها وهي تشير إلى ثقب في الجدار: “ما رأيك لو نحضر كرسيين، لنطل من تلك الفجوة الكبيرة الشاهدة على ما عشته من ضياع وتيه؟”، فيحضر الجدار بوصفه جسدامثقوبا، يحمل آثار الزمن والانكسار، تمامًا كما تصفه إلين سيكسو حين تقول إن “الأنثى تكتب جرحها من خلال الجدار المتهالك الذي يحيط بها”.
رواية “أصوات عالية في الطريق إلى الشمال” لهيام الفرشيشي. دار الأمينة للنشر والتوزيع. ط1. 2025. 164 صفحة.


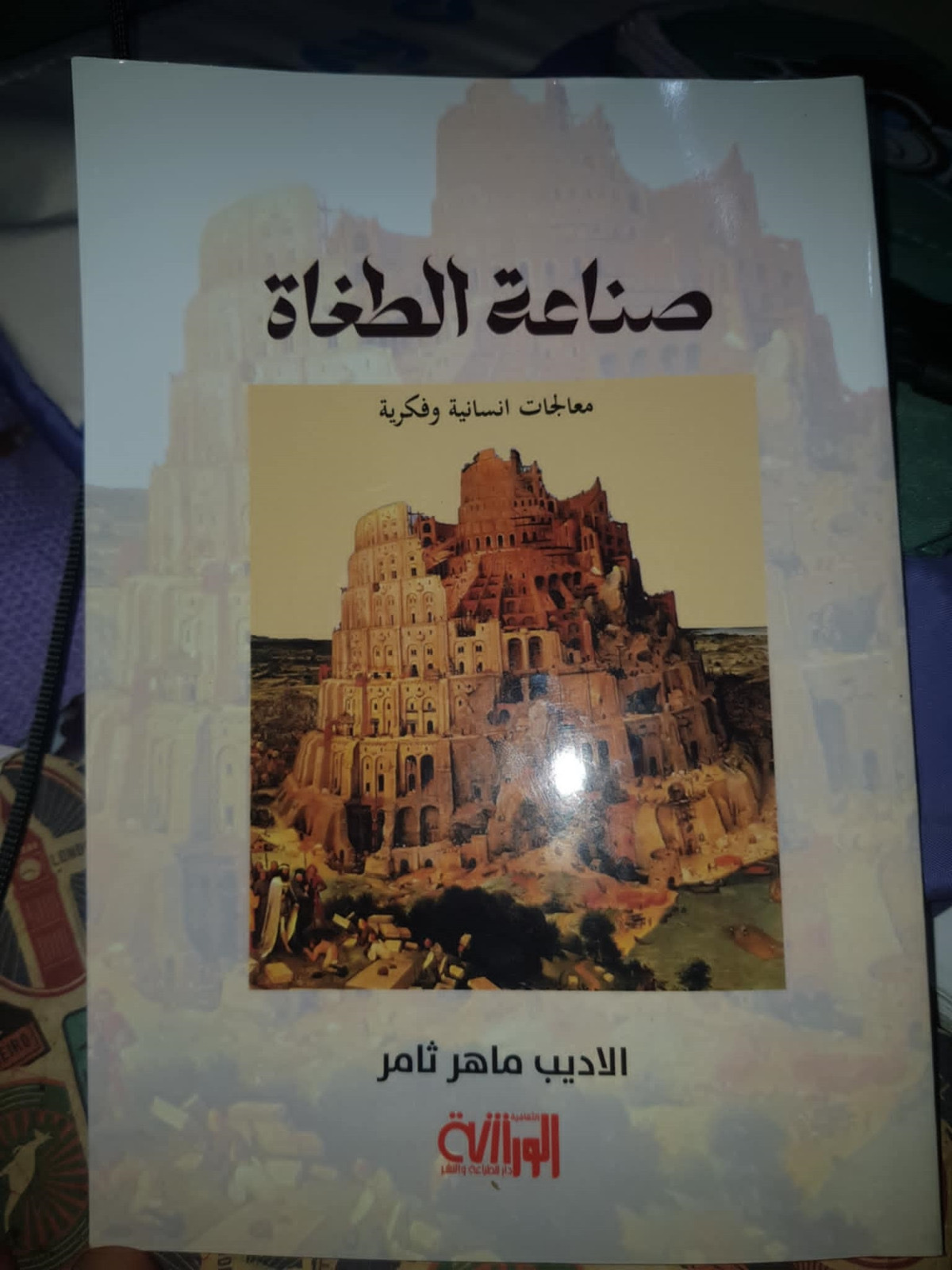

إرسال التعليق