غرائبية وتاريخ وحنين في ‘كويت بغداد عمَّان’
قراءة / زياد جيوسي
من العنوان للرواية الأولى للكاتب أسيد الحوتري الأردني الجنسية والفلسطيني الهوية بعد سبعة كتب تراوحت بين القصة ودراسة نقدية وكتاب بحثي وقصص مشتركة مع كتاب آخرين وكتاب للأطفال، نستنتج أن “كويت بغداد عمَّان” تدور بين المدن الثلاثة التي عنونت الرواية والصادرة عن الآن ناشرون وموزعون في الأردن عام 2022، وبغلاف يحمل صور الحافلة التي كانت تنقل المسافرين قبل هزيمة 1967 بين الكويت وبغداد وعمَّان والشام وبيروت والقدس، ولا أعتقد أن الكاتب يتذكر هذه الحافلات فهو مواليد 1974 في الكويت، ولكن من هم بعمري بالتأكيد يتذكرونها بطفولتهم وقبل احتلال القدس من الصهاينة، والغلاف الأخير يحمل صورة الحافلة وصورة الكاتب وفقرة من الرواية، والرواية تقع في 247 صفحة من القطع المتوسط وبطبعة أنيقة، واهداء: “إلى ذلك الطفل الذي يحتضر في داخلي، والذي لا يزال يحيا على أرض الكويت”، وهذا دلالة على مدى الحنين للكويت والأيام الخوالي.
قبل أن تبدأ الرواية وضع الكاتب في صفحة مستقلة آيات من القرآن الكريم، وفي الصفحة التي تلتها تنويه أن النص لا علاقة له بالواقع وأن أي تشابه يكون صدفة مجردة، ومن ثم يضع مشهدين الأول بعنوان سعيد وهو فتى في السادسة عشرة من عمره خرج من بيته في الكويت غاضبا في ظل منع التجوال، وأطلقت عليه القوات العراقية التي كانت تسيطر على الكويت بتلك الفترة النار بعد هروبه وعدم الانصياع للتوقف، وفي هذه اللحظات “سيرى هذا الغلام، ابن السادسة عشر، ما تيسر من ماضيه، أما في الفصل الثاني فسيعرض عليه ما تيسر من مستقبله، كما سيعرض له الفصل الثالث آماله ومخاوفه”، وفعليا الرواية من ثلاثة فصول هي الماضي والمستقبل والخيال، وكل فصل من عدة أجزاء، بينما المشهد الثاني أشبه بتقديم للرواية بأسلوب مغرق بالرمزية تحت عنوان سعد، والعناوين للمشهدين تعيد لذاكرتي المثل العربي: “انج سعد فقد هلك سعيد”، وهذا يثير السؤال: هل هلك سعيد وهل سينجو سعد؟
الرواية تبدأ بالغرائبية بالأسلوب وتستمر به في مفاصل الرواية التي يرويها سعيد وهو الراوي الرئيس وهو لا يعرف هل هو ميت أو حي أم مسجون في كهف أو مدفون في قبر بعد حادث اطلاق النار عليه وإن كان سيصل لفكرة أنه سجين بسبب ادخال الطعام له بأوقات محددة، ثم نجده في النهاية ص 215 نزيل غريب في سلوكه بأحد المشافي مصابا بمرض الخرف “الزهايمر” وفي لحظات الصحو المحدودة يكتب، ولكن تتجلى الغرائبية أنه لم يكن مريضا ووضع بالمشفى لسبب آخر، ونهاية الرواية حافلة بالغرائبية، وخلال الحديث سنرى أن الرواية فيها بعض من السيرة الذاتية للكاتب فالكاتب اسمه أسيد والراوي سعيد واسم عائلة الكاتب الحوتري والراوي البحتري والكاتب والراوي ولدا في الكويت ودرسا في تركيا، وبالتأكيد ليس ذلك من باب الصدف الجميلة كما أشار الكاتب في البداية، وفكرة الرواية الرئيسة تقوم على استرجاع ذكريات الطفولة في الكويت عبر ستة عشر عاما من لحظة الولادة حتى الاجتياح العراقي في آب 1990، والغرائبية أن نجد في ص 116 الراوي يقول: “قبل خمسة وثلاثين عاما كنت أقيم بالكويت” هذا الاشتياق الشديد والحب المرتفع الوتيرة للكويت وأرض الكويت وشعبها وحكامها، يعبر عنه الكاتب باستخدام مصطلح أرض الخير لوصفها والوارد في أهزوجة استخدمها للوصف، وكذلك الغرائبية في ص 209 تحت عنوان “الكويت كما اراها” لينقلنا في صفحة كاملة لا تحتوي سوى الخطوط وبدون كلمات، وكأنه يريد من القارئ أن يستنتج ذلك من خلال قراءة الرواية.
الرواية تثير التساؤلات منذ البداية فالكاتب استخدم عنوان “سفر التكوين: حولي” كعنوان للجزء الأول من الفصل لأول، وحولي هي أحد محافظات دولة الكويت ومكان ولادة الكاتب، لكن سِفر التكوين هو في التوراة أول الأسفار الخمسة المنسوبة لسيدنا موسى عليه السلام وهو جزء من التوراة العبرية التي زورها حاخامات اليهود وأدخلوا لها الكثير من الاساطير البابلية والسومرية، وفيها كيف من المسائل التي تثير السؤال استخدام الكاتب مصطلح العين الثالثة على صيغة سؤال أول مرة ص27 وهو مصطلح يعود للفترة الوثنية حيث كان يؤمن به أتباع الطاوية في الصين والبوذية والهندوسية في الهند، والمعني به العين الداخلية أي التي يمكن بطقوس معينة والطاقة الكامنة الوصول إلى فضاءات الوعي الأعلى وعوالم مخفية في عقل الانسان ورؤية الروح في الجسد ورؤية أرواح الأموات، والمشعوذون والسحرة يستخدمونها للدخول لعالم الجن والشياطين والبعض في العصر الحديث يسميها النورانية أو البصيرة وفعليا لا علاقة للبصيرة بمفهوم وأهداف العين الثالثة، ولكنها تبقى تواصل لمفاهيم وثنية وطرق شيطانية مخالفة لديننا الإسلامي تماما، وقد أشار الكاتب على لسان الرواي أنه مع تكرار التجربة وصل إلى فتح العين الثالثة وقال: “تتحقق المعجزة! صورٌ كثيرة أخذت في التداعي” ومنها مشهد الصراع على البالون الأزرق.
ومن الملفت للنظر أن الكاتب روى تفاصيل تاريخية دقيقة تخص وعد بلفور ووعد مكماهون على لسان طفل ما زال في الرابع الابتدائي، وتاريخ الكويت ومطالبات العراق فيها بالتواريخ وتاريخ العراق منذ عهد الملكية وصولا لعهد صدام حسين على لسان طفل في الثاني ابتدائي وبالتواريخ الدقيقة، وهذا الحديث عام 1986 ويتوقع فيه عودة المطالبة العراقية بالكويت في التسعينات!! وهذا ما حصل من اجتياح الكويت في آب 1990 أثر الخلاف بين البلدين على حقل نفط وبعد خديعة السفيرة الأميركية للرئيس صدام ودورها بالايقاع به، وحتى لو سمعها مرة من والد صديقه فمن المستحيل أن يرويها بهذه الدقة والتواريخ الدقيقة، ولا يمكن للطفل أو والد صديقه أن يستشرف المستقبل بهذه الدقة وخاصة انه عام 1986 كانت العراق في حرب طاحنة مع ايران، وأيضا ومهما كان هذا الطفل موهوبا فلا يمكنه بهذا السن أن يرسم لوحات فنية تحمل كل الرموز التي رواها لمدير المدرسة ويعجز عنها فنان درس الفن التشكيلي قبل ممارسة طويلة توصله الى الاحترافية، وكذلك ما رواه الطفل أحمد من تحليل لمسرحية “باي باي لندن” هو تحليل نقاد محترفين وحتى لو علمه والده دكتور النقد كيفية التحليل؛ وليس تحليل طفل حتى لو كان متفوق،ولكن في بداية الفصل الثاني يقول عن ذلك أنها افلامهندية وبالتأكيد أن هناك من يتلاعب به، وهذا يعكس الغرائبية في الرواية بوضوح، وتظهر الغرائبية أيضا اضافة لذلك في وجود سعيد بالمشفىوطباعة روايته وخاتمة الرواية.
الرواية تضمنت اشارات اجتماعية أيضا لما هو في داخل المجتمع الكويتي مثل رفض الزواج ممن يطلقون عليهم لقب “البدون” وهم من لا يملكون الجنسية الكويتية، وكذلك التعصب ضد الزواج من مسيحية فلبينية، ورفض المجتمع لابن كويتي لملامحه الفلبينية التي اكتسبها من أمه رغم أنه كويتي أبا عن جد، وكذلك نجد أن الرواية في بعض الأجزاء اعتمدت أدب الرسائل بين سعيد الفلسطيني وحمد الكويتي وخاصة في الحديث عن الأحداث التاريخية والموقف الفلسطيني بشكل خاص، وزج النظام العراقي بفلسطينيين من حزب البعث ومن المهاجرين للعراق في الكويت، كما هو ما قام به النظام السوري في ظل الأحداث في سوريا من الموالين للنظام السوري من الفلسطينيين، وكذلك ما يقوم به الأطفال من تراث شعبي في شهر رمضان.
وفي نهاية مقالي أشير لبعض الملاحظات والتساؤلات، هل يمكن اعتبارها رواية تاريخية؟ في بعض الجوانب يمكن أن اقول نعم ولكن سرد التاريخ والخروج عن اسلوب السرد الروائي في العديد من المواقع في الرواية، يجعل القارئ يشعر بالملل أحيانا مع طول رواية التاريخ الجاف للأحداث بعيدا عن التشويق، وكما أشرت سابقا يشعر القارئ أنه يقرأ كتاب تاريخ أكثر مما يقرأ رواية أدبية، ولعل ما يجعل القارئ أن يشعر بالمتعة في مواقع أخرى هذه الغرائبية في الرواية، والغرائبية كأسلوب أدبي هو الخروج عن المألوف إلى الخيال غير المألوف، فالروايات التاريخية تعتمد على مزج التاريخ في السرد الروائي المتخيل وليس على ذكر الأحداث التاريخية بمساحات واسعة ومتصلة وحشو الرواية بها بحيث خرجت عن أسس وقواعد فن الرواية وأبعدها عن متعة السرد الروائي.
من أما نهاية الرواية المتخيلة رغم مساحة التاريخ والوقائع فيها، سأتركها للقارئ حتى لا أضيع عليه متعة القراءة، وفي ختام هذا المقال النقدي عن رواية كويت بغداد عمان، يتضح أن الرواية ليست مجرد سرد لأحداث مترابطة، بل هي مرآة تعكس واقعًا مليئًا بالتحديات السياسية والاجتماعية والنفسية التي أثرت على شخوص الرواية من خلال حبكتها السردية العميقة رغم الغرائبيةالمغرقة بغرائبيتها، وقد تمكن الراوي أن يسلط الضوء على مجموعة من القضايا السياسية والتاريخية والاجتماعية، فتحدث عن الانتماء وعن الهوية والهجرة والتهجير، والمشاعر النفسية والأحاسيس والمكان والزمان، من خلال اعتماد الرواية على الاستعادة للذاكرة والأحداث، وعلى الرغم من بعض الملاحظات النقدية التي ابديتها في المقال حول الرواية وخاصة الإغراق بسرد التاريخ، إلا أن الرواية مهمة لمرحلة في غاية الأهمية في تاريخ العراق والكويت والشعب الفلسطيني، وكما تساءلت في البداية هل هلك سعيد وهل سينجو سعد؟


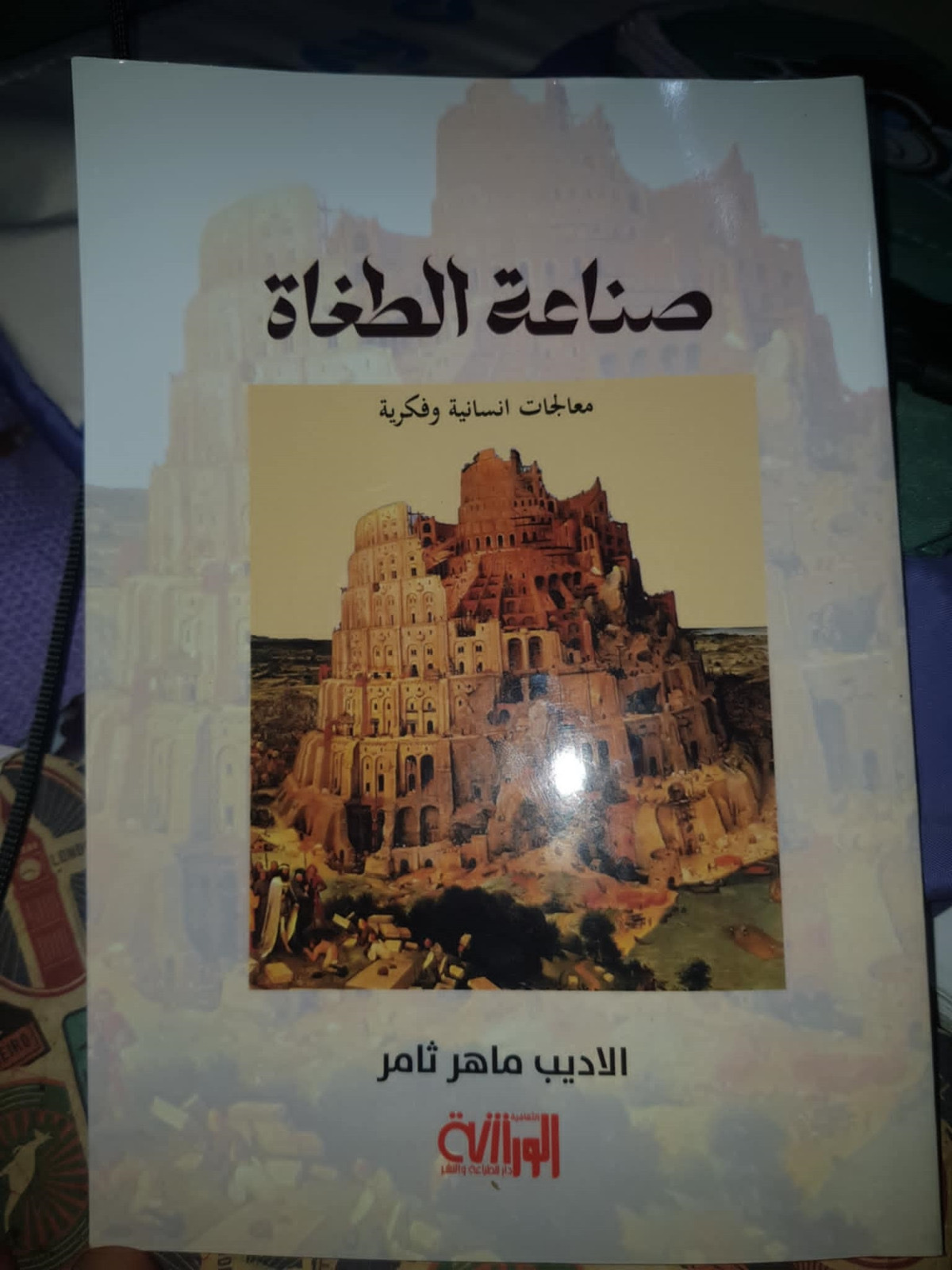

إرسال التعليق